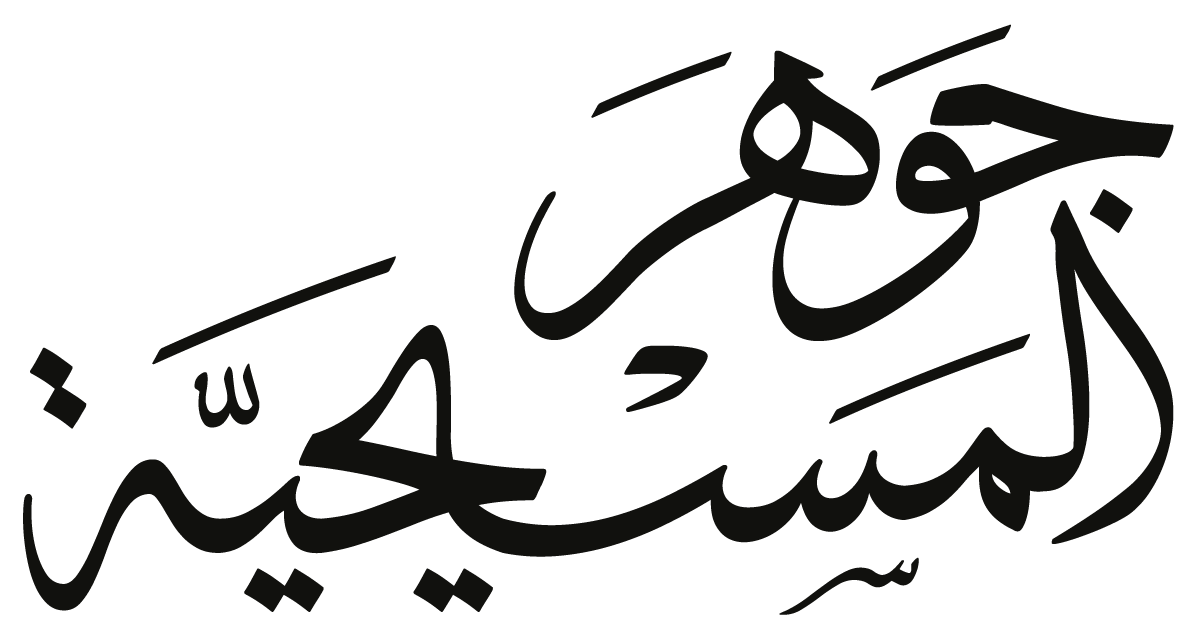بقلم دينيس إي. جونسون
كان زكريا رجلًا مُتقدِّمًا في العمر، موقَّرًا، وكاهنًا مُتميِّزًا من نسل هارون، يخدم أمام مذبح البخور في قدس هيكل إسرائيل الواقع في المدينة المُقدَّسة. أما مريم نسيبة اليصابات، زوجة زكريا، فكانت شابة غير متزوِّجة، تعيش في مدينة الناصرة النائية المتواضعة. وصحيح أنها كانت من نسل داود الملوكي. بدا أن آمال الملكوت قد تحطَّمت، بينما ذبُل شعب الله تحت سطوة هيرودس الأدومي، الذي كان كالدمية في يد روما الوثنيَّة. ولسنوات طويلة وحزينة، طال انتظار زكريا وزوجته، أليصابات، لابنٍ، إذ كانا عاقرين. أما مريم، فكانت على وشك الزواج من يوسف، لتصبح أُمًّا، بمشيئة الله.
لكن الله أرسل خادمه المقرَّب، جبرائيل العظيم، من بلاطه السماوي، ليزفَّ إلى كلِّ واحد منهما، أي إلى زكريا ومريم، البشارة باقتراب ولادة ابنٍ لهما. كان من شأن ابن زكريا أن يعدَّ الطريق، ويُجهِّز شعب الرب لوصول إلههم. وكان من شأن ابن مريم أن يكون ابن العلي، ونسل داود الموعود به، الذي لا نهاية لملكوته.
وبحسب الظاهر، تبدو الأسئلة التي طرحها كلا هذين الشخصين، كرد فعل تجاه تلك البشارة المذهلة، متماثلة. فإن زكريا، الذي تعلَّم الحذر والحيطة بسبب عقود من خيبة الأمل، طلب برهانًا إثباتيًّا، قائلًا: “كَيْفَ أَعْلَمُ هَذَا، لِأَنِّي أَنَا شَيْخٌ وَٱمْرَأَتِي مُتَقَدِّمَةٌ فِي أَيَّامِهَا؟” (لوقا 1: 18). أما مريم، فإذ أصابتها الحيرة أمام هذا الوعد بالحبل دون زواج، عبَّرت عن حيرتها وارتباكها قائلة: “كَيْفَ يَكُونُ هَذَا وَأَنَا لَسْتُ أَعْرِفُ رَجُلًا؟” (لوقا 1: 34).
لكن التوجُّه القلبي الكامن وراء هذين السؤالين كان، في حقيقة الأمر، أبعد ما يكون عن التشابُه. فعلى الرغم من تديُّن زكريا (لوقا 1: 6)، ففي تلك اللحظة الحاسمة والحرجة، نبع سؤال هذا الكاهن الشيخ من قلبٍ يرفض تصديق البشارة الآتية إليه من عند الله، والتي بدت أروع من أن تكون حقيقيَّة. ولهذا استحق توبيخ المبعوث السماوي، الذي قال له: “أَنَا جِبْرَائِيلُ ٱلْوَاقِفُ قُدَّامَ ٱللهِ، وَأُرْسِلْتُ لِأُكَلِّمَكَ وَأُبَشِّرَكَ بِهَذَا. وَهَا أَنْتَ تَكُونُ صَامِتًا وَلَا تَقْدِرُ أَنْ تَتَكَلَّمَ، إِلَى ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِي يَكُونُ فِيهِ هَذَا، لِأَنَّكَ لَمْ تُصَدِّقْ كَلَامِي ٱلَّذِي سَيَتِمُّ فِي وَقْتِهِ” (لوقا 1: 19-20). في المقابل، وعلى الرغم من حيرة مريم، تلقَّت تطويبًا نبويًّا موحى به من الروح القدس، لأنها “آمَنَتْ أَنْ يَتِمَّ مَا قِيلَ لَهَا مِنْ قِبَلِ ٱلرَّبِّ” (لوقا 1: 45). ومن المفارقة العجيبة أن سؤال زكريا قوبل بردٍّ، وهو تسعة أشهر من البُكم، في حين لم يُقابَل سؤال مريم بردٍّ، عدا من بعض الصور البلاغيَّة المبهَمة المُتَّصلة بالخلق وخيمة الاجتماع: “اَلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ يَحِلُّ عَلَيْكِ، وَقُوَّةُ ٱلْعَلِيِّ تُظَلِّلُكِ” (لوقا 1: 35؛ راجع تكوين 1: 2؛ خروج 40: 35). ومع ذلك، وسواء في وجود أو غياب تفسير، آمنت مريم (على عكس إبراهيم وسارة قديمًا، في البداية) بأنَّ “لَيْسَ شَيْءٌ غَيْرَ مُمْكِنٍ لَدَى ٱللهِ”؛ ومن ثَمَّ، فقد خضعت لمشيئة الرب لأَمَته الصغيرة (لوقا 1: 37-38؛ راجع تكوين 18: 14).
وعد الله بالمستحيل، وآمنت مريم، بينما لم يؤمن زكريا. وهكذا، سبَّحت مريم، في حين ظل زكريا أبكمًا (إلى أن تمَّت كلمة الله، وعندئذ انضم هو أيضًا إلى جماعة مُسبِّحي الإله حافظ العهد، لوقا 1: 64-79).
إن نشيد العذراء مريم “Magnificat“، [وهي الكلمة المأخوذة من الكلمة الأولى في ترجمة جيروم اللاتينيَّة لهذا النشيد، وهي “تُعظِّم”] يُمثِّل إقرار إيمان صادرًا من قلب ليس “مدفوعًا” بقدر كونه مُنجذبًا إلى الأمام بفعل الوعود. فإذ كان صدى تحيَّة أليصابات (“أُمُّ رَبِّي”، لوقا 1: 43) لا يزال يتردَّد في أُذُني مريم، انتقل تأمُّلها من الانبهار والتعجُّب من ذلك الشرف الذي أغدقه الله مُخلِّصها عليها شخصيًّا (لوقا 1: 46-49)، إلى تهلُّلٍ بتدخُّله القدير لأجل جميع الذين “يَتَّقُونَهُ”، ذاكرًا رحمة تجاه إبراهيم ونسله، كما كان الوعد للآباء (لوقا 1: 50-55).
يُظهِر نشيد الْعذراء مريم ثقتها بوعود الله بالوعد من ناحيتين. فأولًا، هذا النشيد مشبَّع بنصوص نبوءات كتابيَّة من العهد القديم، حيث نرى إشارتها في الختام إلى ذِكر الله لرحمته التي وعد بها الآباء، ونجد أنفسنا منغمسين في أصداء تلك الوعود نفسها: “تَبْتَهِجُ نَفْسِي” (مزمور 35: 9؛ إشعياء 61: 10)؛ “بِإِلَهِ خَلَاصِي” (حبقوق 3: 18؛ مزمور 25: 5)؛ “نَظَرْتَ نَظَرًا إِلَى مَذَلَّةِ أَمَتِكَ” (1 صموئيل 1: 11؛ راجع 9: 16؛ تكوين 29: 32)؛ “تُغَبِّطُنِي بَنَاتٌ” (تكوين 30: 13)، “ٱلَّذِي صَنَعَ مَعَكَ تِلْكَ ٱلْعَظَائِمَ” (تثنية 10: 21)، “قُدُّوسٌ وَمَهُوبٌ ٱسْمُهُ” (مزمور 111: 9)، “يَمِينُ ٱلرَّبِّ صَانِعَةٌ بِبَأْسٍ” (مزمور 118: 15-16)، “رَحْمَةُ ٱلرَّبِّ فَإِلَى ٱلدَّهْرِ وَٱلْأَبَدِ عَلَى خَائِفِيهِ، وَعَدْلُهُ عَلَى بَنِي ٱلْبَنِينَ” (مزمور 103: 17)، “بَدَّدْتَ أَعْدَاءَكَ” (مزمور 89: 10)، “مَلَأَ نَفْسًا جَائِعَةً خَيْرًا” (مزمور 107: 9)، “يَا إِسْرَائِيلُ عَبْدِي، يَا يَعْقُوبُ ٱلَّذِي ٱخْتَرْتُهُ” (إشعياء 41: 8-9)، “ذَكَرَ رَحْمَتَهُ” (مزمور 98: 3)، “تَصْنَعُ … ٱلرَّأْفَةَ لِإِبْرَاهِيمَ، ٱللَّتَيْنِ حَلَفْتَ لِآبَائِنَا مُنْذُ أَيَّامِ ٱلْقِدَمِ” (ميخا 7: 20). وطوال النشيد، نسمع صدى الشكر الذي قدَّمته حنَّة لله، الذي أزال عار عقمها، والأهم من ذلك، الذي يُهبِط الجبابرة، ويُصعِد الضعفاء، بواسطة الملك الذي كان من شأن صموئيل ابنها أن يمسحه في النهاية (1 صموئيل 2: 1-10). وقد كانت أفعال الإنقاذ المُتفرِّقة، وفترات الراحة الوقتيَّة، التي وُهِبت لإسرائيل في الماضي، ظلالًا تمهيديَّة، تُعبِّر عن الموعد الحقيقي، الذي جاء بعد طول انتظارٍ من رحم العذراء مريم.
ثانيًا، مع أن الطفلين (يوحنا المعدُّ للطريق، ويسوع )، اللذين من خلالهما كان سيتمم الله أن الإنقاذ والتغيير اللذين تهلَّلت بهما العذراء مريم، لم يكونا قد وُلِدا بعد، ولكن بعد الشطر الأول من النشيد، تحوَّل زمن الأفعال من المضارع (“تُعَظِّمُ نَفْسِي”) إلى الماضي (الماضي الخبري البسيط في اللغة اليونانيَّة)، كما لو كانت مريم تنظر من موقعها إلى الماضي، إلى نصر تحقَّق بالفعل، وإلى نجاة اختُبِرت بالفعل. كانت روما وهيرودس لا يزالان يحكمان أرض الله، وكان هناك كهنوتاً فاسدًا لا يزال يتحكَّم في هيكل إسرائيل. فكيف أمكن للعذراء مريم، إذن، أن تقول إن إلهها كان بالفعل قد “شَتَّتَ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ بِفِكْرِ قُلُوبِهِمْ”، و”أَنْزَلَ ٱلْأَعِزَّاءَ عَنِ ٱلْكَرَاسِيِّ”؟ بينما كان المساكين الأتقياء لازالوا يعانون تحت الطغيان والجزية. وكيف أمكنها أن تؤمن بأن الله كان بالفعل قد “رَفَعَ ٱلْمُتَّضِعِينَ”، و”أَشْبَعَ ٱلْجِيَاعَ خَيْرَاتٍ”؟
علمت العذراء مريم جيِّدًا أن عاضد إسرائيل، الذي ابتدأ تتميم الفداء بصورة فجائيَّة من خلال الجنين الصغير، الذي كان ينمو في رحمها بطريقة معجزيَّة وغامضة، لن يخفق في تتميم قصده وخطته حتى النهاية، مهما كان سيكلّفها الأمر … بل ومهما كان سيكلَّف الله نفسه. وإذ كانت العذراء مريم قد تسلَّحت بهذه الثقة المُتَّضعة بإلهٍ يفي بوعده، لم يسعها سوى أن تخضع لقصده المُغيِّر للحياة لأجلها. وهكذا يمكننا نحن أن نفعل اليوم، بل يجب أن نفعل بتلك الثقة بإلهً يفي بوعوده.